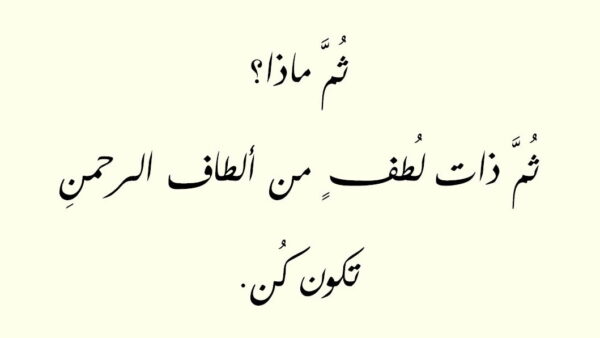مساء الياسمين، مساء العاشقَين ومساء العاشقين، مساء النور والرياحين، وبعضٌ من حبٍ وأكوامٌ من حنين.
تعود جذوري لبلادٍ تسأل عن الحال قائلةً: كيفك؟
وتنمو أغصاني وتزهر ثماري في بلدٍ تسألُ عن الأحوال قائلةً: شلونك؟
تعدّدت الأسئلةُ وتفقّد أحوالك والاطمئنان عليها واحد، كيف حالك؟ ما هو لونك اليوم؟
هل أنت بخيرٍ يا صديق؟ هل صلّيت الفجر على موعده؟ هل تذكرتني بالدعاء؟ هل استيقظت إلى العمل بلا منبّه؟ أم أنّك ذهبت متأخّراً على عجلٍ لم تلمّع حذاءً ولم تتناول لقمة؟ ويح قلبي المسكين إن كنت هكذا، أيّ إنجازات تلك التي تختتم بها يومك وقد بدأ مثل هذه البداية، أرجو أنّك لست كذلك، كم أرجو ذلك.
الصّورة التي أرسمها لك يلوّنها هدوءٌ ونظامٌ متناهٍ كذلك الذي التي يُسكرنا في تفاصيل لوحات الفسيفساء الجداريّة، تبدو وكأنّها أحجار دومينو متراصّة بفنٍّ وإتقانٍ مثيرٍ للدّهشة.
بالمناسبة، أحبُّ اللوحات الجداريّة كثيراً، ولكنّي لا أشتريها، ليس على المهاجرين اقتناء ما لا يملكون تهجيره معهم هجرةً تلوَ هجرة، الرضا صفةٌ جيّدة، أنا أقتنعُ بإيجابيات الحبّ عن بعدٍ وحسناته شيئاً فشيئاً، ألا يبدو ذلك مريحاً لك يا ملك البُعد؟
تعرفُ بالتّأكيد أنّ الكاتب كاذب، وأنّه يستمتع بإخفاء نفسه بين السّطور، وبالمناورة مع القارئ لمعرفة شيء من غموضه، وتعرف أنّنا قد نكتب أنفسنا حيناً ونكتب ما نتمنى لها أحياناُ، وتعرف أنّ حالمةً مثلي لا تتمنّاك حبّا رزيناً إلى هذا الحدّ أيضاً، يتوق التّمرّد إلى بعض جنونٍ وكثيرٍ من علامات التّعجّب، أُنقّب عن حبٍّ لا يخشى شيئاً، كطفلٍ اشتهر في الحيّ بدقّ الأجراس وطرق الأبواب، والهرب ضاحكاً إلى البعيد، يحّرك سكّان منزلٍ كاملٍ بدَقّةٍ ودِقّةٍ على غير ميعاد، تأهباً لطارقٍ مشاغبٍ مجهولٍ تلاشى بمجرّد أن أمسكوا المقبض وهمّوا بفتح الباب.
لم يعد هناك أطفالٌ ولا طفولة، ولا ضحكاتٌ ولا أبواب، ملأت الكاميرات حياتنا، واستعضنا بها عن الأعين السّحريّة كانت تُثقب بها الأبواب، لمعرفة الطّارق.
كنا نتسابق إليها، يبدو مشوّقا النظر من خلالها، مشوّقٌ أكثر، ضيفٌ ظريفٌ يضع ابهامه عليها من الجهة المقابلة كي لا نعرفه، كم ضيّعت الظرافةُ الثّقيلةُ من علاقات، وكم أقامت خفّة الدمّ علاقات أُخرى.
أريد أن أخبرك شيئاً زبرجد، أنت لن تعرفني مهما حاولت، كما لن أعرفك مهما بحثت، لأننا كلّ يومٍ ننضج ونكبر ونتعلّم، أنت اليوم لست ما كنت عليه في آب اللّهاب ولست ما ستكون عليه في تشرين الأول أيضاً، الأدباء يتغيّرون كثيراً، عدد الصلوات الخمس والفصول الأربعة.
لحظة! هل قلت أديب؟
نعم قلت، حسناً، أعترف، لطالما تمنيتك صاحب قلم، أعرف أنّ هذا يبدو إجراميّاً!
فالأدباء عامّةً لا ينجحون في الارتباط، ويخفقون كثيراً في العلاقات، ليس سهلاً أن يتفهّم عصبيتك الكتابيّة شريك حياةٍ واحد، تمرّ بطقوس أثناء الكتابة تشبه ما يصفونه بـ: «تحضير الجنّ» إن صحّ القول، قد تغلق الستائر وتعتّم الجوّ في وضح النّهار، قد ترفع صوت الموسيقى صاخبةً كي تختم نصاً في آخر الليل، قد تضع صورة أحدهم خلفيّةً لجوّالك وتتأملها صباح مساء استسقاءً للإلهام، وقد يضطرُّ شركاء السّكن لتقبيل يديك رجاء إنهاء كتابتك سريعاً لأنّ التخمة السّمعيّة أصابتهم من الأغنية اضطررتهم لتكرار سماعها معك قسراً سبعمائةً وخمساً وثلاثين مرّة ونصف، قبل أن تكسر جارتكم المذياع.
بعض الكلمات تمرّ بمخاضٍ أقسى من هذا بكثير، ليس عاديّا أن تكتشف ذات تعبيرٍ أنّك ولدت مُدوّناً وكاتباً، يبدو الوصف للوهلة الأولى برّاقاً، لكنّه بين الكتفين يكتنز لعنةً على العارف والمعروف، يجب أن تملك طاقة حبٍ فيّاض وكمّاً من الانسانية الهائلة الدّفاقة، لتراعي أحاسيس من ملَك في خافقه مشاعر ألف شخصٍ جُمعت في شخص، يبدو الوصف رقيقاً لكنّه في الحقيقة ثقيلٌ لا يُحمل.
محبّة الأديب فرض عين، لكنّ عشرته وتحمّل مزاجه فرض كفاية يثاب عليه من أقامه مقامه؛ أن تكون كاتباً يعني الكثير، أنت تشعر بالكلمة حتى لو أغمضوا عينيك عن الصّور وأصمّوا أذنيك عن اللّحن، أنت تشمّ العبير الذي لن يستنشقوه أبداً، وتلمس الدفء الذي ما عرفوه يوماً، أنت كتلة حواسٍ لم ينقص منها شيء، بل زادت حتى فاضت، تستطيع أن تخطّ روايةً حزينةً عن نملةٍ أضاعت طريق عودتها إلى البيت حاملةً حبة السّكر، وما من مانعٍ يمنع قلمك عن شرح مشاعر عائلة صرّار الليل قد لقي مصرعه تحت نعل حمّام بيت جدّتك!
حتّى حقيبة السّفر المهترئة الحمراء، تستطيع أن تكتب عنها جريدةً ومائة قصيدة، تُعبّر لي فيها أنّ ما يحول بيننا ورقة وقلم، وقلب أديب.
أراها عائدةً من فيلادلفيا الرّوح منذ عدّة أيّام، هذه الحقيبة ليست لنا، تعود بجلدها المتكسّر، بدواليبها على وشك الانكسار، بمقبضها المتأرجح مكسواً بالملصقات من شتّى الأسفار.
حقيبةٌ حُبلى بلا تخطيط، كعادةِ الحمل في شرقنا على مرّ الزّمان، تحملُ متفرّقاتٍ تموينيّةً معظمها موجودةٌ عند أقرب بقّال، لكنّ أمهاتنا كلّما كبرن بالعمر عشقن «التّواصي» أكثر، ونقل الحاجيّات بين البلدان أكثر وأكثر، العائلة التي لم تمارس تقنية الوقوف فوق حقيبة السّفر لمحاولة إغلاقها لا نعطيها الجنسيّة، ولا تنتمي إلينا بأيّ حالٍ من الأحوال، تلك الوقفة طقس من طقوس السعادة والضّحكات الرنّانة، ترتفع معها الأيمان أننا لم نأخذ شيئاً بلا قيمةٍ بين الأغراض، وينقصُ الإيمان لحظة مشاهدة أكياس الجبنة تخرج واحداً تلو آخر أمام موظّف الميزان بالمطار، تنشقُّ الأرض وتبتلعنا لو دفعنا له أربعين دينار ثمن الزّيادة في الوزن لا يلقي لها حبّ الأمهات والخالات والعمّات بالاً.
سألني ليُحرجني يوماً، هذه الجبنة، أين الخبز؟ ضحكت وقلت: في الطرف الثاني من الحقيبة، لا تستعجل رزقك، لقد اشترت الحجّة خمسة كيلوجرامات منه لأن أمريكا بجلالة قدرها لا تملك رغيفاً عربياً يشبع صهرها هناك؟!
عملية ولادة الحقيبة الحمراء الدّولية كانت معقّدة، فيها أكياسٌ لا بدّ أن تسافر داخلياً ثانيةً، يحسبون المسافات بين المدن تشبه مشوارنا إلى جارتنا أم الوليد في الحارة المجاورة.
أحتاج تهويتها، وضعتها على درجات منزلي، أتأملها صباح مساء، تستلطفني أن أملأها بالهدايا للصبيّات الأربع ووالدتهنّ وجدّتهن، تريدني أن أتخيّل مقاساتهنّ الجديدة، تغمز لي كلّما مررت بجانبها، متى تذهبين إلى السّوق؟ متى ما ملأتني سافرنا سويّةً إلى عمّان.
تقول عمّان، وتُمسكني من اليد التي تؤلمني، تعرف كما يعرف كلّ من يعرفني أنّي أؤمن بالخرافة التي تقول أن كلّ إنسان يدفن في التُّربة التي خلق منها، وأنا أظنّني خلقت منها. كيف؟ ولماذا وعلى ماذا؟ ربّما لأنها كانت وستبقى ملاذاً يوم لا يكون لنا ملاذ.
لو أنّك شاهدت ثلوجها، وشهدت شتائها، عروسٌ جميلةٌ لا تكبر، أحبّها وأحبّ من يحبّها، وألقاك هناك يوماً من الأيّام.
كن بخير، كلّ خير، أديباً غريباً حبيباً أريباً مريب، يحبُّني اليوم، ويحبُّ عمّان كلّ يوم.
حقيبة حمراء