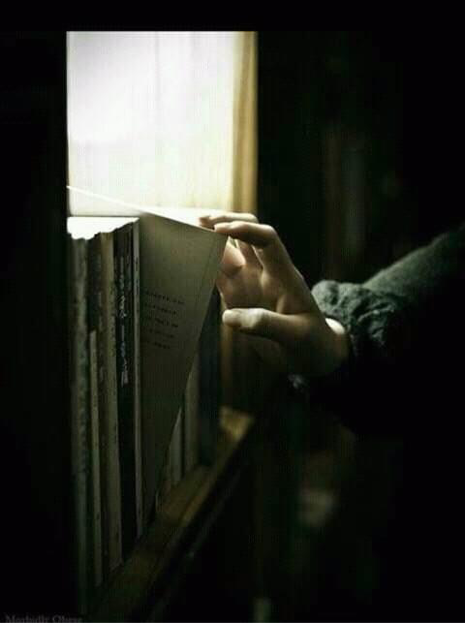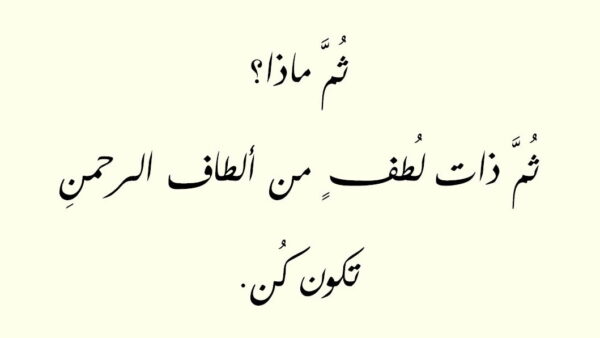لديّ علاقةٌ غريبةٌ مع الموت، جرأة ٌأغرب على كتابة رسائلَ للأموات بين فترة وأُخرى! أحياناً أضطر لإنقاذ بعض الرسائل المتهورة التي تتزحلق من محبرتي على أوراقي رغماً عني، لا خيار لدي وقتها، إما أن تنهمر الكلمات أو تنهمر الدموع.
بعض الأحبّة العابرين نعمة وجودهم في حياتنا عظيمة، يأتي فقدهم أعظم ممّا يُطاق ويُحتمل، يتطلّب مشقّةً في التّعود على تلاشي أجسادهم بيننا وبقاء الأرواح سلوة لا نراها بل نحسّها كلّما أغمضنا العيون، لا أعرف إن كنت قادرةً أن أكون متألقةً كذلك في حياة من أحب، أرجو ذلك.
استطعت مؤخراً أن أتصالح مع الموت بوهمٍ غريب!
لطفاً، ضع تحت كلمة وهم خطّاً أحمراً، لأنها تمثل اعترافاً تاماً أنّي أعرف وأعترف أنه وهم! لكنني عليه أتكئ أحياناً، وربّما عليه تقتات روحي وتعيش، اتكاءٌ أحمق خيرٌ من سقوطٍ مروّع.
ما هو هذا الوهم؟ رسائل البرزخ، منه واليه!
لقد مرت عشرة أيام على الرسالة تصل من أحدهم كي لا أرى في تلكم السطور إلا شيئا واحداً، الجدُّ _يرصُّ البراغي _ من بعيد، قدوتك في الحياة أرسل جندياً ضرب ضربةً على العقل ومشى، دون أن يدري، بل أظنه يدري.
لم أستطع أن أقرأ بين السطور إلا: انتبهي واثبتي!
كان التوقيت رهيباً، ولا أستطيع أن أرد المعروف اليوم على “انتبهي” إلا ب “شكراً ” ولا أزيد.
جائت الكلمات على استحياء، تماماً مثل: لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوف شَيْئًا، وَلَو أنْ تَلقَى أخَاكَ بوجهٍ طليقٍ، كانت معروفاً يذكّرنا بالجذور، وجهاً يذكّرنا بالاستقامة على الطريق.
أقف أمامها مشدوهة، لم أستطع أن لا أقف عندها، سألت نفسي ألف مرّة: هل كانت مجاملة؟
لا أعرف سلاماً لي بهناء سكوني بين هذه الحروف، القارعةُ أنّ ما يسكنني يزعج سكوناً، ويُقيم قياماتٍ ومعارك يتجابه فيها حرفي مع من أحب، وعلى الكاتب أن يختار أي الفريقين سوف يخسر، لا مجال لربحٍ تام، ولا أوجع من خسارة تامّةٍ أيضاً.
ويمضي العمر، لا أنا كتبت، ولا أنا توقفت عن الكتابة يا زبرجد، حتى أنت، بكُلِّك تتملكُ الحنين لا أملك فهماً لك، من أنت؟ أتُراك من سكّان البرزخ معهم وينكر قلمي وقلبي ذلك كي تستمر بالسفر إليك الحروف؟
من زبرجد؟
سؤالٌ يُطربني، صفيه لنا؟ نستمتع بالحديث عنك، نضحك، وندمع، لا نعرف لك عمراً أو شكلاً أو لغةً أو مكان، كلّ الذي نعرفه روحاً استحقت هذا الحب العظيم، استحقتها بجدارة، لا أفهم أين ينام قلبي كلّ يوم قرب قلبك في مكانٍ لا أعرفه؟ وربّما تعوّدت أن لا أفهم، أراك يوماً، وتستردّ الديون وتصفّى الحسابات.
أكتب بشغف، ولا أكتب بانتظام، أحبّ ولا أفعل، ثمّة كلماتٌ أمحوها بين السّطور تجعلني أشعر أنّ بصمتي ومكاني في الحياة ليس هنا مجدّداً!
أحلم بلقب ” الأديبة ” منذ الطفولة، تروقني صحبة القلم منذ أعوام، يوتّرني التّشجيع: استمري، تصيبني بالكركبة: لا تتوقفي، كلما شجّعني أحدٌ قعدت من الرهبة مع القاعدين، وتساءلت بمرارة علقميّةٍ حنظليّةٍ: هل تراني أستطيع؟
هل أملك كلمةً لها وصول، أم أنهم الناس كالعادة، ينفخون بالوناتٍ من الزّهو المزعوم لنا لفترةٍ بقلوبهم الحمراء وابهامات اعجاباتهم الزرقاء، نصدّق للحظة، وينفجر البالون مع أوّل ارتفاعٍ بسيطٍ يلسعهُ فيه شعاع الشمس.
أظنُّ أنّك مُربٍّ جيّد، تستحق مني ومن غيري كلّ ولاء ودعاء، كبرنا وعرفنا أن ليس كل الأساتذة يستحقون، أواجه حالياً محاولاتٍ عقيمةً في المحافظة على أدنى حدٍّ من الاحترام المتبادل بين المعلّم والمتعلّم قبل فوات الأوان، تأتي النصيحة نفسها من أناس لم يلتقوا يوماً: لا تتوقعي أن كلَّ المعلّمين على صواب، الحكمة ضالّة المؤمن، ولكننا اليوم في زمن فتنة.
لقد تعلّمت درساً بليغاً مؤخراً وأنا أجاهد في توجيه هدف الحرف ونيّة القلم: نحن من نسمح بوضع المطبات النفسية ونحن من ندوس عليها ونمضي، لا أرى تحدياً إلاّ في ولادة الفكرة التي ستدور حولها الكتابة، وهل كانت تستحق جهداً أصلاً؟ لأن التدوين بلا هدف واضح يشبه مشوار الجمعة المنتظر بلهفةٍ ستّة أيام طوال الأسبوع المكتظّ بالأعمال، ثمّ بدى سخيفاً جداً مخيّباً للآمال لعدم التخطيط التام للرحلة والمعرفة المسبقة للوجهة.
لا أحد يملك الحق ولا القدرة على وأد الحرف، كلُّ ما في الأمر أنّنا في زمنٍ نملك فيه حريّة اختيار موعد الولادة المتعسرة.
اللهم ارزقنا حرف تشويقٍ لفكر الكاتب لا تسويقاً لشخصه، حرفاً ندرك قبله وبعده أننا موعودون ب: “اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا “.
ادع لي لطفاً، أن يفتح الله لحرفي الفتح المبين، دمت ومن تحب بخير، جزيت الجنة وما تتمنى.
ميلاد مَلَكة