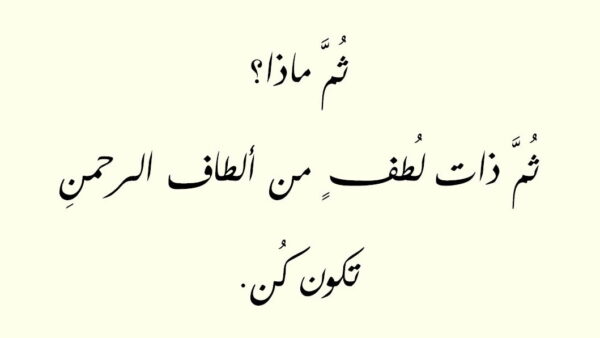حسناً أعترف، بطيئةٌ جدّاً كما وصفتني في بداية رسائلنا الحواريّة بطريقةٍ أذهلتني وكأنّك تعرفني منذ بدء الخليقة: «تحتاجين لعمر نبينا نوح» لتبلغي المجد الذي ترنو نفسك إليه، تسمّرت لحظتها طويلاً لقدرتك على فهمي بتلك السرعة الخارقة، تساءلت كثيراً أيُّ رأسٍ يحملُ بين كتفيه؟ وأيّة بصيرةٍ تُبصر بها روحه قبل عينيه؟ لقد فكّ الشيفرة دون أن يراني بعد، وقرأ الروح على بُعد آلافِ الكيلومترات من خلف شاشة، دون رؤية صورة، دون تكوين قاعدةٍ بصريّة يرتكز عليها، أو معرفة أوضاعٍ اجتماعيّةٍ يطمئنّ إليها.
منذ تلك الرسالة، لدي نهمٌ لمعرفتك أكثر، وفضولٌ لتبادل أطراف الحديث معك أكثر وأكثر.
ومنذ ذلك اليوم، شعرت بتعارف الأرواح فيما بيننا منذ تسعمائةٍ وخمسين عام، لكنني فضّلت أن أتواضع بتقليصها لخمسمائة أثناء تشبيهي لذلك التّقارب كي لا تفرد ريشك كالطاووس زهواً بنفسك كَعادتك، ولا أقلّص لحظةً واحدةً بعدها أبداً، ولا أسمح بذلك حتّى وإن صار حال لقاؤنا العامر إلى اشتياق، وكان مآلُ تعارفنا العابر إلى فراق، فأنا أعي حقيقة ما شعرته روحي تجاه روحك، ولا فكاك لي ما عشت من ذاك الشعور.
كثيراً مّا تلتصق الكوارث بالحبّ السريع لعجلةِ ما تتعرّى مطبّاته أمامنا دفعةً واحدة لا تفقه في فنّ التدّرّج شيئاً، فتُعمينا عن السؤال عمّا وراء الكواليس أحياناً وتجعلنا نكرّر خطأنا الشّهير لمرّةٍ ليست بالأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة.
ما جرى من مقادير الحبّ في العمر كان، كثيراً مّا نندم، لأنّه خلّف في النفوس ندوباً بشعةً جداً حالت بيننا وبين تقبّل ما آلت إليه الأمور، نهاياتٌ لا يُطاق حملها ولا تحمّلها ولا نحبّ أن نفكّر بها، ولا حتّى أن يذكّرنا فاعل خيرٍ لطيفٍ ظريفٍ خفيفٍ أنّا مررنا بها، لا نندم على حب العمر الأوّل الطاهر العذريّ، وإن توسّعت رؤيتنا لاحقاً وفهمنا متأخّراً أنّه ما كان حباً وما كان يمتّ للحبّ بصلةٍ حتّى، و لا ننسى الأنثى المغرورة والكهرمان يستلم صناعة الحبّ عبثاً في المنزل، و لا نستطيع أن نتناسى ولو مجاملةً أننا عشنا دهراً ضد ما تُمليه عليه قلوبنا انتظارا لـِ لاشيء.
شيءٌ فظيعٌ يتحرّك في صميم الذّات حين تُدرك أنّك أكلت المقلب وَشربت السمّ الزّعاف ووقعت في المصيدة، واللّي ضرب ضرب واللي هرب هرب.
يبدأُ العتب ويطول العتاب، لو أنّك فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ويتهافتُ ملائكة البشر المصلحون بزعمهم لجبر القلوب المنكسرة واصلاح العلاقات المتعثّرة، وتشهق الرّوح ألماً شهقةَ مودّعٍ مُشيرةً بالبنان إلى حظّها: هذا الحظّ، لا أريده، لا أريده، لم أعد أريده.
نفس الحظّ الذي كنت منذ أعوامٍ تشهق في حبّه خوفاً من فقده ألف شهقةٍ وشهقة، وا عجباً لتقلّب الأيام وتقلّب القلوب.
ليلة ولادة الحبّ نقول بثقةٍ مفرطةٍ على عجل: القلب أصبح في خطر، مخاض اللقاء عسر، نبض القلب يضعف إلى توقّف، الحبل السريّ لعلاقتنا يلتف حول رقبة المستقبل، و فوق همّ شبه استحالة الوصل نتساءل بيأسٍ بعد الشّوق اتّصل لأشهر: هل نفقدُ هذا الحبّ قبل التعرف عليه وسكون جنوننا قليلاً إليه؟
تتوالى خلال العمر خيبات الأمل بالحبّ، فلم يُعطَ مفتاح سرّه إلا قليلٌ من العالمين.
قد تسألُ نفسك مليار مرّة متناسياً أدب السؤال: لماذا اختارني القدر بمثل هذا القلب لمثل ذلك الحب؟
لماذا بدى كلّ شيءٍ حقيقياً لأوّل وهلة، ثم هوينا معاً إلى القاع، إلى الحضيض السحيق، لم يحررنا منه إلا وعيٌ واستشاراتٌ مكثّفةٌ بأنّ القلب يجب أن يتخلى عن الأمل الواهي الزائف بأنّا نستطيع تغيير أحدهم ما لم تكن له رغبةٌ بذلك، حاول أعواماً متتالية أن تغيّر إنساناً بلا رغبةٍ بلا لهفةٍ بلا شغفٍ بلا رؤيةٍ بلا حلم بلا أملٍ بلا همةٍ بلا حماسٍ للعمل، أبشّرك بأنواع الفشل المتتالية لمحاولاتك البائسة أن تعلّم متعاجزاً كيف لا بدّ للحرّ أن يعيش القوامة ويشارك في رعاية الرعيّة و أداء الحقوق كي تستمر الحياة كريمةً بالستر مجمّلةً بالصبر مكمّلةً بالحبّ أولاً وثانياً وأخيراً.
لكنّ الحبَّ لا يُقيم جدار البيت يريدُ أن ينقضّ على أصحابه برؤية استهتار الشّريك وتملّصه من مسؤولياته، الغريب أننا ندرك شناعة ما نمرّ به وما نحن عليه ولا ننبس ببنت شفةٍ عمراً مديداً.
معظمنا حمقى، نجاهدُ ونرغبُ بصدقٍ أن نحيا حباً صالحاً عظيماً مثل ذلك الذّي عاشه عن قناعةٍ ورضا أجدادنا، تُزفُّ عروسهم لمنزلها بالأبيض خمسين عامٍ، كمتوسّط الحسبة تقريباً، إلى أن تُحملُ على الأكتاف منه متوشّحةً به ثانيةً إلى بيتها الأخير، تنامُ الحسناء منهنّ وإن لم تكن حسناء العمر كلّه على وسادةٍ واحدة، تستر ما في بيتها وتتكئ على بسيط عملها ويسير مالها وظهر أبيها وعزّ ذويها في زمنٍ جميلٍ كان فيه أهلها أهله.
من يصدّق أيّ زمنٍ عصيبٍ يمرّ به الحبّ الآن؟ ننقعُ الأحبّة في بيوتنا أعواماً، وإذا ما عطشنا لحبّهم شرقنا من أوّل رشفة، ما عاد للحبّ طعمٌ يُذكر، ما عادت القبلات تُسمن كسابق عهدها، ولا حتّى الضّماتُ تُغني من جوع.
ويسألنا العشّاق أن نسامح! والله لا نسامح، لا يعلمُ أحدٌ شناعة ما نحاول ترقيعه دون جدوى، دون أي جدوى.
يبدو كلُّ حبٍّ مُرهقاً، حدّ الجنون، حدّ التمرّد الصامت، حدّ الغضب الهادئ، حدّ الخروج عن السيطرة، حدّ الموت على قيد الحياة، حدّ الإنطفاء، حد ّالذهول، حدّ فقدان الشغف، حدّ السؤال: لماذا فقدت البريق؟ أين اختفت الضّحكات؟ متى فقدت الحيوية والجنون؟ لم تكن يوماً كذلك.
الحبُّ الأحاديُّ في حضرةِ وجودِ المحبوبِ أخرق القلب اللامسؤول شعورٌ مقزّزٌ في كثيرٍ من الأحيان.
خلف باب الليل تتعارك آلام الجسد يتلفُ شيئاً فشيئاً ليلةً بعد ليلةٍ بحثاً عن تفسيرٍ مقنعٍ لمثل هذا البيان، بعضهم في الودّ حيٌّ ميّتٌ بل ميّتٌ حيّ، نذكّر أنفسنا بين فترةٍ وأخرى بأنّه يتنفّس، والله يتنفّس، بيد أنّه لا قلب له.
هل سمعت يوماً عن محبٍّ يعشقُ من رئتيه؟ أنا لم أسمع بعد، ولا مانع لديّ أن أحظى بشرف التّجربة الأُولى بأن أستنشق الهوى بدلاً من أن أنبضه، ولكن أنّى يكون لي هذا، قد أسمعت لو ناديت حيّاً.
“قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ” يا زبرجد الزّمان، “قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّه”ِ.
زبرجديّات