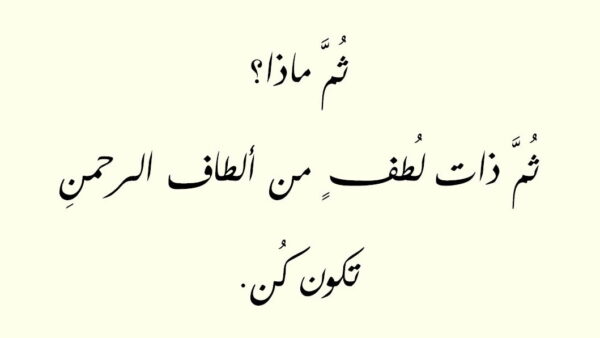أستودع الرحمن خفقات قلبك وأنفاس صدرك، طمئنّي هل أنت بخير؟
مررت اليوم بكثير من المشاعر، كنت أكتب لأحدهم رسالةً حين شعرت برغبة ملحّة في الكتابة لك، أتأخّر عنك كثيراً هذه الأيام، لا عذر لي، أعرف، وأنت لك السبعون.
لا أعرف لماذا تذكّرتك وسط زحمة المشاغل والمهام، هل كان بسبب الأغنية التي سمعتها الليلة فطارت بي إليك؟ أم بسبب عطر المسك الأبيض يذكرني بالجنة؟ والجنة في خيالاتي مكانٌ جماله السرمديّ يكمن في أنّه يجمعني بك إلى الأبد.
النبلُ والأصل أن أتذكّرك حال الفرح أكثر من حال الحزن، أظنّ بأنّ أحد رسائل عمري نشر البهجة والسرور، أستطيع أن أنكفئ على نفسي حال الألم، لكنّي لم أعرف ألماً كألم ليلةٍ تتبع يوماً ضحكت فيه ملء قلبي واستطعت أن أزرع الضحكات على قلوب الحاضرين دون أن اسمع من بين ضحكاتهم ضحكتك.
تذكّرت لقائنا الأخير، أزعجتني كثيراً، هل يتشاجر جميع العشّاق على هذه الشاكلة؟
تغضب فأغضب، تصرخ غيرةً فأصرخ، لا أعرف من أين أوتيتُ شجاعةً لأهدّدك بالخروج من حياتك قبل الخروج من منزلك إلى الأبد، الذي أعرفه أنّي في تلك اللحظة لم أستطع تفسير ملامح وجهك مطلقاً.
لماذا ظهر ذلك الطفل المخنوق أمامي أنا؟
من قال لك أنّي في كلّ أمرٍ أستطيع المساعدة؟
من أوهمك بأنّي ساحرة!
المطبخ ثانيةً؛ أهرب إليه، تسمع صوت قفل المفتاح، يُجنّ جنونك من جديد، تطرق الباب ولا أرغب فتحه، تستحق منّي كلّ عقاب، تطرقه دونما كلل، تسألني من خلفه: هل ستغادرين حقاً، هل سيعلم أحدٌ عمّا جرى بيننا؟ أسمع نبرة الصوت تنخفض شيئاً يسيراً، تسألُ بنبرةٍ وددتُ أن أصدّقها: هل تُسامحينني؟ هل تعودين غداً؟
أفتحه فتحاً يسيراً، خمس سنتيميترات فقط لأتأكّد إن كانت نظرة العينين تتّفق مع كلمات الشفتين، أتأمّل فيهما كلّ رجاءٍ ومائة وجعٍ وعشرةَ أسرارٍ وألف حب.
لطالما فصلت بيننا مسافةُ أمانٍ لا تقلّ عن ستّة عشر، لابدّ من تركِ مسافاتٍ حسيةٍ ومعنويةٍ كافيةٍ أثناء بناء العلاقات، فكيف بعلاقةٍ وليدةٍ عمرها سبعة أشهر وقُبلة.
تفتح ذراعيك مع فتح الباب، تلفّني على عجلٍ بلا استئذان، ويخرس الحرف لحظةً من الزمان.
تعطّرني بعَذْب الكلمات فلا أستطيع فهمك، كنت تجرحني منذ لحظات والآن تتوسلني للبقاء ساعة!
أصلّي، أهدأ قليلاً، وأفكّر في أسلوبٍ أُنهي به هذه الزيارة بلطفٍ قبل أن أغادر.
أعود إلى المطبخ، خَبْزُ كعكة شوكولا حالاً قد يهدّئ من حدّة التوتر، ثلاثون دقيقةً ويبدأ سحر الفانيلا بفعل فعلته اللئيمة، أفتح باب الثلاجة وأناديك سائلةً: تريد معها نكتار التّفاح أم شاياً أحمر؟ تُجيب بقلبٍ أخضر: شايٌ حلوٌ كالعادة بالتأكيد.
لطالما أحببتَ أن تكون قطعتك مثلّثةً كبيرة، لا تحبّ المربّعات أبداً، هل يا تراك تقصد بهذه المثلثات أن تنبّهني إلى أننا نعيش علاقة حبٍّ مستحيلةً معقّدةً بين ثلاثة؟ كلّ مغفّلٍ بينهم يحّب حبيب الآخر، ولا وصول لحبٍّ مستقرٍ يُقرّ العين في حياة أحدهم.
أتذكّر الضمّة، كانت غريبة، دافئة كما لم أتخيّل، لم تكن ضمة حبٍ أو شوقٍ أو اعتذار، كانت ضمّة شئٍ آخر عجزت بلقيس أنوثتي عن فهمه، لم تخف منه، غير أنها لم تخضع له أيضاً.
نعم أحبّك، وأكثر مما تتصور، غير أنّي أحبّ نفسي أكثر، ولا قيمة عندي لتصرّفٍ استدراكيٍّ من بعد فعلٍ أهوج، ربّما تمنّيتها سابقاً كثيراً، لكنّي لا أحبّ أن ترتبط ذكراها عندي بشجار.
لماذا قسمت لك مثلثاً كبيراً بعض الشئ؟ لا أدري! شئٌ مّا لا أعرف له شرحاً ذاب في روحي وأنا أزيّنه بالشوكولاته الذائبة، هل تنتهي يوماً عادة اناث الشرق في التعبير عن الأحاسيس عن طريق الابداع في المطابخ والرسم بالكاكاو؟
أهمُّ بالرحيل، أتذوّقها، يبدو سكّرها قليلاً بعض الشئ، لا أدري كيف التهمتَها دون أن تنتقد ذلك، بل انك طلبت المزيد حتّى! هل تجاوزت قلّة حلاوتها اليوم لأنّي أغرقتها لك بكريما الشانتيه مثلاً؟ ربّما.
نقف بصمتٍ عند الباب، تضع يمينك على خدّي وتقول: أنتظرك غداً، عديني بالحضور، ألتفت دون أن أجيب، وأرحل.
تحملني كثير من الأسئلة في مثل هذا اليوم أثناء الرحيل من عندك، لماذا تخبو قيمة الأشياء حين تأتينا في غير وقتها؟
أصل إلى البيت متعبة، متعبة جداً، ولا يتعبني أحدٌ مثلك، أنام ليلتي نوماً كسيراً كثيراً، يزعجني رنين منبّه الصّباح، نسيت أن ألغيه، لا أريد أن ألقاك على موعدنا ككلّ يوم، فتومض على أطراف أحلامي قائلاً: أرجوكِ.
اتفقنا مُسبقاً أنّ الموعد يُلغى إن تأخّرت عليك، تعاهدنا أن نحفظ علينا أوقاتنا كي نحفظ حبّنا ما دامت الحياة.
يرنّ جرس المنبّه مرّة بعد مرّة، وأُخرس رنّاته غفوةً بعد غفوة، إلى أن أستيقظ بعد غفوة الموت الأخيرة، وأقفز من السرير قفزة شوقٍ قرّر أن ينسى وجع الأمس، وإذ بي من بعدها أركض إليك ركضاً لم أركض من قبل مثله صبحاً.
أرنّ جرس الباب، تفتحهُ مرتدياً بيجاما النوم السوداء، تفتحه على مصرعه قبل أن تكتمل الرّنة، قبل أن تمشّط شعرك ودون أن تغسل وجهك، وعلى طرف الشّفتين آثار الشوكولاته.
لا أعرف من أقنعك بأنّ عطرك سيفلح في أخذي إليك، لا أخفيك سراً، أنا في الحقيقة أحبّ شعرك غير ممشط! لا تفرح، هذا ليس لوسامتك أيها الأفندي الجميل، إنّما لأنّك بهذا المنظر تشبه نفسك من الدّاخل كثيراً، لا أحد في الكون يعرفك مثلي، أعرف كم أنت متعب، أعرف ذلك عدد ما ثرثرت لي آلاف الذكريات وأنا أستمع بقلبي وأسمع بأذني وأستمتع بكلّ روحي.
تكرر وتؤكد لي أنّها كانت أطيب كعكة، لا أصدّقك إلا حين أتفقّد المطبخ، يبدو أنها كانت فطورك فعلاً بل وعشاءك أيضاً ليلة البارحة وصباح اليوم، ويح قلب المحبّ المسكين كم نبض بالسُّكّر كي يسكر، كنت سأسامحك بطيب خاطرٍ دون أن تأكلها كلّها يا حلواً أحلى من أيّ كعكة.
أحببت لقاءنا، أحببت كيف انفكّت عقدة لسانك الغزليّة أخيراً، أحببت عينيك تترقّب خلع السترة كي ترى الهندام، اعتدتَ أن تراني بملابس رسميّة واليوم آتيك بفستان، شيفون بنفسجيّ سادة وهفهاف، قلادة ذهبية بحجرٍ عاجيَ، سواران، وخاتم.
مراتنا الأولى كثيراً ما تكون محرجة، لم يكن غزلاً تقليدياً، ولم أتخيّل أن أتهوّر وأرتدي أمامك في مثل هذا اليوم فستاناً من بعد عشرات الجينزات، أعترف.. كان من المنطقي أن تفسّره سماحاً وأكثر.
أتعطّر، أتّجه نحو الصّالة، وأكاد أن أتعثّر، تضع جهازك اللوحيّ جانباً وتشير إليّ بالجلوس إلى الأريكة جوارك متنهّداً بصوتٍ مرتفعٍ معبّرٍ عن شئٍ من الإعجاب اللطيف: «الله».
كان الكعب عالياً هذه المرّة، تقول: «سندريلا»، ثم تتبعها بالسؤال: هل لي أن أسرّك سراً؟
: «حتّى سندريلا لم تكن لتكون سندريلا لو أنّها لم تخلع من قدمها فردة الحذاء عمداً تلك الليلة»!
أبتسم، تناولني قطعة شوكولا، وتقول: «صباح الشوكولا».
*****
كم غابَ غيرُكَ لم أَشعُرْ بغَيبتِهِ
وأنتَ إن غبتَ لاحتْ لي سَجاياكا
أراكَ مِلْءَ جِهاتِ الأرضِ مُنْعكِساً
كأنّما هذه الدنيا مَرَاياكا
فواز اللعبون