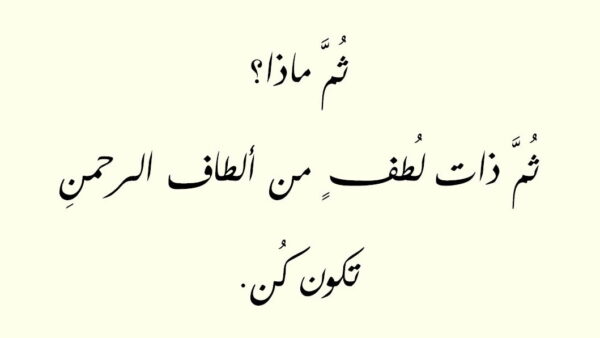لماذا نغيب؟ ولماذا نحضر؟
ما الذي يدعونا إلى الانطفاء من بعد التوهّج؟
ما الذي يجعلنا نلمع من جديد؟
لماذا تبدو بعض أيامنا متشابهةً أحياناً؟
لماذا يمرّ النّاس على أعمارنا ومعهم نخوضُ التّجارب؟
ماذا يريدون منّا؟ وماذا منهم نحن نريد؟
ما هي الإرادة؟
كنّا صغاراً، ألطف أحلامنا شراء غزل البنات الورديّ لا أكثر، الاستمتاع بأكله، بدبقه الذي يزعجنا ولكننا نحبّه، ما أكثر الأشياء التي نحبها رغم أنّها تضايقنا حدّ الازعاج!
هل تذكر؟ أنا أذكر، ملمس الرمل المزعج بين أصابع القدمين الصغيرة، كبرتُ ولم أكمل بناء قلعةٍ مميزةٍ واحدة، كلّ القلاع بنيتها مستخدمة كأساً كرتونياً شرب به أحدهم الشّاي ثمّ أعطاه لي، أو لنقل، كل القلاع التي بنيتها بدت لي في النّهاية متشابهة، كان غريباً أنّا كنّا نصرّ قبل الذهاب عن الحديقة أن نهدم ما بنينا بأنفسنا بدلاً من أن يلعب به أحدٌ من بعدنا سوانا، أو يهدمه، كنا وما زلنا نؤمن أن خسارتنا بأيدينا قد تبدو أخفّ على قلوبنا من خسارتنا بأيدي غيرنا.
لقد كبرتَ كثيراً يا سُكّر، لماذا ما زلت تحبّ الدّبِق من الحلوى، أيشعرك ذلك الشعور بأنّنا لم نكبر بعد؟
هل أنت مثلي يا سكّر؟ تتمنّى عبثاً لو أنّ السّنة تدور كلّ سبعمائة يومٍ وليس كلّ ثلاثمائة!
هل يرعبك الاقتراب من عمرٍ مّا؟ هل تسأل نفسك كلّ صباح ماذا سأكون قد أنجزت حين بلوغه؟
تقول الخالة أنّ حفيدها أحرجها: جدتي كم عمرك؟
هذا السؤال لا نحبّه، لا نحبّه، والنّاس لا تملّ سؤاله، أجابته بأنّها منذ ستةٍ وأربعين عامٍ بلغت العشرين، وانتهى الحوار.
لماذا نخاف أن نكبر؟ بالأمس كنّا نرتقب ذلك بفارغ الصبر واللهفة، أريد أن أكبر كي أستقلّ، كي أسافر، كي أجني نقودي بنفسي، كي أصرف بدل أن يُصرف عليّ، كي وَكي، وألف كيٍّ وكي.
لكنّنا ما إن شعرنا بأنّا أوشكنا على ذلك حتّى تراجعنا، لا يبدو ذلك مناسباً لكنّنا فعلنا.
قالها من قبلي كثير، وسيقولها من بعدي أكثر، كلّ جيلٍ يهوّن على الذي يليه الطّريق، والملتقى الجنّة: «كلّ عمرٍ له فرحه وميزته»، غير أنّا وددنا أن نعلق عند مرحلة الفتوّة وأن لا نغادرها، الذي حدث أنّها هي التي علقت بنا ولم تغادرنا، بدى ذلك واضحاً حين لم نستطع إخفاء ضحكاتنا الرنّانة مع أطفالنا في مدن الألعاب، لم تفلح كلّ عباءات الهيبة والوقار في تغطية شهواتنا التي لطالما شابهت شهواتهم اللطيفة: حلوى جيلاتين ومقرمشاتٌ، كريم كراميل وكثيرٌ من السكر.
لا أذكر التّاريخ، ولكنّني ذات حلمٍ التقيتُ شاباً وسيماً كما لُطف همسِ حرفِ السّين، بدى لي وكأنّما حيّزت له الدنيا بحذافيرها، تربّع على قمّة برجٍ لا يستطيع الصّعود إليها أحد، بأقدامٍ حافيةٍ صعدت إليه، ويا ليتني لم أفعل!
كلّما اقتربت منه خطوةً أكثر، ابتعدت عنه ملامح الشباب أكثر فأكثر؛ رأيته من بعيد، جالساً أمام مكتبه الجلسة التّقليديّة التي تتخيّلها عن كلّ مديرٍ بائسٍ يشعر بالفراغ لأنّ دخل شركته مستقرّ ولأنّ روتين يومه كذلك وفي وحدته شوقٌ لتحدٍّ جديد، لمشكلةٍ مع موظّف؛ مكتبٌ بالغ الفوضى، بدت لوحة المفاتيح خاصّته كرغيف خبزٍ مكسوٍّ بالسمسم! تلتفّ حولها كاسات الشّاي الفارغة، يمدّ العميد ساقيه إلى الطّاولة، ويميل بظهر الكرسيّ الدّوار ميلةً ليست بسيطة، تواجه نظّارته ونعل حذائه البنّي ذو الرأس الحادّ شاشة الحاسوب، وكأنّ للغبار عليه والنّملة الصّريعة تحت قدميه حقاً في إلقاء نظرةٍ معه على ما يجري في هذا العالم الشاسع.
كان منسجماً متأمّلاً الصّفحة الرئيسيّة في موقع مارك الذي عرّى الأوجه والأرواح منذ ستة عشر عامٍ ليصير متعةً عند البعض وهَوَساً عند الآخر، لا تعرف وصفاً دقيقاً له، عالمٌ مكتظٌّ بالمشاعر والقلوب الحمراء، يشبه ساحة حربٍ أو سوق جمعة، أحياناً يبدو كحانةٍ وأحياناً يبدو كمعبد، إحتار فيه النّاس، بعضهم اتخذه منصّةً ثقافيّة والبعض ضيّع بدلاً من الوقت أوقاتاً لا تعدّ تصيّداً للتفاهات فيه؛ وكلٌّ يغنّي على ليلاه، ولا أحد يعرف ليلانا سوانا!
كان قد بلغ ذروة الملل فلم يغلق الباب، لم أحتج له طرقاً، لم أرَ إلا ظهره، صلعة رأسه، شيباً كثيراً حولها، وثنيات تجاعيد لا تعدّ طرفي الرّقبة.
تراجعت خطوتين إلى الوراء، أربكتني المواجهة، ارتطمت بالمكتبة، سقطتُ على الأرض وسقطت معي عشرات الكتب، التفّ بكرسيّه الدوّار نحوي التفاتةً سريعة، رفع الصّوت قائلاً: من هناك؟!
أمامه أنا! يضع نظّارةً سميكة! ما هذا السؤال؟
ما زلت أتنفّس بصعوبة، الاحراج يكاد يدفنني في أرضي لقلة الذوق أن وصلت ساحته بلا استئذان، لم أستطع أن أرى وجهه بوضوحٍ بعد، وقف بظهرٍ منحنٍ وراح يبحث عن عصاه الخشبيّة التي كانت قد سقطت فوقي أيضاً، مددت يدي إليها وناولته إيّاها بصمتٍ مطبق، فسحبني إليه عبرها قائلاً: دعيني أراكِ!
تواجهنا أخيراً، وبلمح البصر تغيّر تعريف الوسامة في قاموسي، لا أدري كيف اجترئتُ على السؤال: لماذا تضع نظّارةً ما دمتَ كفيفاً؟
ضحك ضحكةً أعادت الكتب لرفّ المكتبة وأقامتني من على أرض الغرفة، وقال قولةً لا أنساها: «النّظارات لم تكن يوماً للمبصرين يا عزيزتي»؛ أهداني واحدةً مع عصا، أدرك بأنّي مازلتُ كفيفة البصيرة، وعلّمني مفهوماً جديداً عن الفتوّة في الحياة.