بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
عزيزتي: إيما!
كيف حالكِ يا صغيرتي؟
أكتب لك من بلادٍ لا أظنّ أنّك تسكنيها، شمال خطّ الاستواء، من هضبة نجدٍ أناديك وأقرؤك السلام، فهلّا رددت النّداء؟
يقول العمّ بأنّ ذلك حدث ذات شتاء، كتب بأنّه يبحث عنك ولا يجدك.
وأظنّ أنّه يبحث بطريقةٍ غير مدروسة، جميع الأطبّاء مثل ذلك، يجيدون مهنتهم باحترافيةٍ ليس لها مثيل، يملكون انسانيّةً لا تقدّر بثمن، لكنّهم للأسف لا يدركون كثيراً مما ندرك ولا يتقنون غفيراً مما نتقن، نحن ساكنات كوكب زمرّدة.
يقول «عمّو» أنّ ذلك حدث منذ احدى وعشرين عام، يقول بأنّك ولا بدّ الآن بعمرِ طالبةٍ جامعيّةٍ أو ربّما عروس؛ هذا العمّو طيب القلب جداً!
كيف سنشرح له أنّ عرائس اليوم أعمارهنّ على أعتاب الثلاثين؟ كيف سنلقّمها للمجتمع أنّ بناتنا تردن أن تنجزن كثيراً من الإنجازات وتدرسن الأكثر من الدّراسات وتُحصّلن وفير العلامات والشهادات قبل أن تفتتِحن بيوتاً وتربّين أبناءً وترافقن شركاء حياة.
يفترض العمّو أنّك ما زلت تحملين الاسم الذي يعرفه، يبحث عنك أولاً، ويبحث معه كلّ من قرأ ما كتبه ثانياً؛ بعض الكتابات تضطرّنا أن نعيشها حرفاً بحرف، استطاع عمّو أن يشعرنا بالبرد القارص، سقطت قلوبنا من بين الضّلوع مع تلك السقطة في جوف النّهر المتجمّد.
مضى أسبوع مُذْ تأذّى قَوْسا قدميّ بسبب مغامرتي السّخيفة لسقي نباتات الجدّة في الحديقة ظهراً دون ارتداء خفٍّ لدقيقتين كقلّة تقديرٍ لشمس الصّيف الحارقة لا أكثر؛ فوجدتني أثناء قراءة المقال أشعر وكأنّ التهاب الجلد المحترق التئم، وبأن الألم خاصّته تجمّد لمجرّد تخيُّلِ الصقيع في ذروة أيّام الصيف؛ أيّ سردٍ صدوقٍ ذلك الذي استطاع أن يسافر بي عبر الزّمن أثناء القراءة؟! لا أدري..
عندما قال الله تعالى في كتابه الحكيم: “إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ“، تمنى كلُّ ذو قلبٍ حيٍّ أن يكون عالماً؛ كيف أكون عالماً يا حليمة؟ هل يكون ذلك بصفّ الشهادات وكثرة الكتابات؟
كيف نكون في الحياة ذوي بصمةٍ وأثر يا صغيرتي؟
= تقولين صغيرتي يا خالة وأنا أدرسُ في الجامعة!
_ نعم أقول، طالما أنّي لا أتخيّلك إلا قطعة اللحم الغضّة تلك التي استطاعت بحولٍ من الله أن تقول لتلك الليلة بكلّ قوّةٍ رغم كلّ الظّلمات: «أريد أن أعيش».
في جعبتي كلماتٌ أرغب في التعبير عنها ولا أعرف هل أُوفّق في قولها أم لا، لكنّني سأفعل والله الموفّق.
ربّما كان الأصل أن تبتدئي رحلة البحث أنت عن عمّو..
لا بدّ لك من ارباكه والاصرار على سؤاله: لماذا أنت الذي حملتني وليس بابا؟ هل تعمّد أن يحمّلك الرسالة؟
هل تعرف يا عمّو أنّي كنت من الله إليك رسالة؟
هل أدركت ليلتها أنّك ستقضي عمركَ كلّ عمرك ترى عيني حليمة في عيون كلّ أطفال البلاد؟
ستراها دوماً، في عين اليتيم والشريد والطريد، في بؤس الجائع ومتسوّل التعليم، في حنين المغترب وأنين المهاجر.
= ما نفع أن تجدني يا عمّو؟
ربّما أنا اليوم صبيّةٌ محجّبةٌ بالغةٌ عاقلةٌ راشدة، قد كانت تلك أطول مدّةٍ في تاريخي أقضيها بين ذراعي رجلٍ إن صحّ القولُ: غريب، أو لنقل: ليس من أرحامي.
إن حدث والتقينا، بالتأكيد سأكتفي بنظرةِ امتنانٍ واحترامٍ إلى العينين وابتسامةٍ خفيفة، ربّما نحتسي معاً فنجان شايٍ دافيءٍ وأعتذر عن ما سببته لك من متاعب وكبّدتك إيّاه من مشاقٍّ ليلتها، ثمّ سأهديك مرطّباً للجلد الذي تأذّى من تكسّر الجليد ذاك تاركاً وذمةً على الروح قبل الساقين وأمضي، وتمضي من بعدي الحياة كما مضت من قبلي، ويقول القارئ أنّ لقاءنا في الحياة تُوّج بعنوان: «رسالة حياة بين ذراعَيْ ليلة».
أريد أن أسألك سؤالاً، وربّما أن أُسرّك سرّاً: هل تصحُّ مناداتك عمّو إن التقينا؟
من يدري؛ ربّما تغيّر رأيك إن رأيتني، ويرجع بنا الزّمان عشرين عاماً إلى الوراء، وتقرّر أنني كبرتُ وحدي دون أن تكبر، وترجّح أن أناديك باسمك أختاً صغيرة.
لم تكن يومها بعمر أبٍّ لتشعر تجاهي أنّي ابنتك؛ لكنّها المشاعر البشريّةُ بطريقةٍ مّا تحدثُ رغماً عنّا أثناء رحلة العمر، لكلّ شعورٍ حكايةٌ فريدةٌ وَرواية؛ كيف ينهمر الشّعور؟ لا ندري.
لعلّ تلك الليلة كانت رسالتي إليك على مرّ الحياة، بعض النّاس يعبرون على دُنيانا برسالةٍ واحدةٍ فقط والبعض لنا منهم عند كلّ ملتقىً رسالة، نصُّها أنّ «كلّ عمٍّ هو أبٌ لكلّ طفلٍ في العالم»، شاء أم أبى، استطاع أو لم يستطع، كان ذلك منطقياً أو لم يكن.
من يدري يا عمّو؟
هناك كثيرٌ من الاحتمالات تلتفّ حولي، تصرُّ الكاتبة ثانيةً بأنّك لن تجدني ما لم تُجِد البحث، تقول بأنّ ذلك لا يتطلّب كثيراً من الجهد، إنما بعضاً من تكتيك النّساء قليل، وشيئاً من قدراتهنّ الخارقة ومهاراتهنّ الحارقة في التعامل مع خوارزميّات الشّبكة العنكبوتيّة.
لو تعرف يا عمّو لو تعرف!
هذا أمرٌ لا ينبغي لي أن أطلعك عليه من أسرار المملكة النسائيّة، الخالات في الشّرق كيدهنّ عظيمٌ كما لا تتخيّل، يطرقُ الواحد منكم بابنا خاطباً، «فَيُفَيّشْنَ» تاريخه منذ لحظة الولادة إلى ساعة طرق الباب، يخرج من غرفة ضيوف منزل العروس وقد توحّدت قوى جارات العمارة ودايات الحارة لمعرفة عدد الشيبات في رأسه والليرات في جيبه، وماذا عمل فيما علم؛ تُقِمْنَ قيامته قبل أن تقوم، وتنْبشْنَ تاريخه دون ذنبٍ مذكور؛ أفلا تُفلح نسوةٌ موهوباتٌ بالفطرة مثلهنّ في العثور عليّ وإيجادي لك؟
تستطعن، لا يتطلّب ذلك أكثر من مهرجان قهوةٍ ثقيلةٍ معشّقةٍ بالهال وحفلة شايٍ مخمّر، ومشقّة يومين أحبّ على قلوبهنّ من العسل المصفّى، لتصلك أينما كنتَ صُوَري ومحلّ إقامتي ومقرّ جامعتي وأخبار والديّ وأسماء إخوتي الجدد الذين لم يعودوا جدداً بلا شك.
غير أنّني أصدقك القول بأنّي لا أريد لذلك حدوثاً الآن، أخشى أن صميم رسالة تعارفنا في الحياة ينتهي يوم اللقاء، وأنا لا أحبّ للرسائل أن تموت، أحبّ أن تكون خالدةً كرمىً لعيون الأطفال، أريد أن تبحث عنّي في بريق عيني كلّ طفل، أن تتذكّر أن الأمل باقٍ إلى يوم القيامة، وأنّنا رغم الأسى سنتعلّم، سنكبر، وسنعيش.
ما ضرّنا إن لم نلقَ حليمة؟
ما ضرّنا وفي الشتات ألف حليمة؟ وفي الغربات ألفُ ألفِ حليمة؟
أشكرك لأنّك كتبت شيئاً حرّك القلوب وهيّج المُقل، وذكّرنا بذات الشعور في طريقنا عبر المجهول نحو النّور، ربّما بعض كلماتنا لا تموت وإن متنا.
= أتراكِ متّ يا حليمة؟ كيف تجرُئين على قول مثل ذلك!
_ وهل تبقّى في الوطن أو خارجه حيٌّ يا عمّو؟
متنا ألف موتةٍ وموتةٍ قبل أن نعيش، عشنا حياة الموت قبل أن نحيا الحياة، بربّك ماذا تريدني أن أقول؟
ألم يخطر على بالك للحظةٍ أنّي لربّما عشت حياةً عاديّةً تشبه حياة الكثيرين؟
تشاجر والديّ على غير ميعادٍ وانفصلا! وتركا لي تربية الصّغار وحمل المسؤوليّة، هل تصدّق!
أحيا حياةً أبأس ممّا ينبغي لمن هنّ في عمري؛ والحمدلله في الأولى والآخرة؛ لطالما عاتبتك كثيراً من المرّات لأننا نجونا من ذلك النّهر؛ ما كنت أظنّ أن أرى حياةً مثل هذه الحياة ولكنّي رأيت، رغماً عنّي رأيت.
ذكّرني يا عمّو، ماذا تعني كلمة حياة؟
لماذا كنت مُصرّاً في تلك الليلة أن نعيش؟
لماذا أشعر أنّك ليلتها علّمتني معنى «الإحسان»؟
أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك، لعلّك عبدت الله في تلك الليلة بحمل طفلةٍ عبر عبور بوتقة الموت إلى اكسير الحياة، لا شكّ أنّ تلك الطّفلة تقدّر قيمة الوقت وتعيشه بما يرضي الله كما يليق بذلك الإحسان وتلك العبادة.
كيف حدث لذلك العيش أن يُعاش بأعجوبة؟
هل كنتُ قدراً لطيفاً لهذه الدّرجة في حياتك يا عمّو؟
أم أنّك وددت أن تذكّرني ما عشتُ أنّ الحياة حلوةٌ ولا بدّ لها أن تُعاش بما يرضي الله مهما اشتدّت الظلمات ومهما تكاثر الظّلم ومهما بلغ صقيع اليأس منّا مبلغه لأنّها عقيدةٌ وجهادٌ كما علّمتمونا.
شكراً يا عمّو، شكراً لأنّي عند كلّ مطبٍّ فيها أتذكّر أنّنا تجاوزنا تلك الليلة بإيماننا برحمة الرحمن معاً، شكراً لأنّك كنت في حياتي رسالةً أيضاً كما كنت لك كذلك، أريد أن نتّفق على ميعادٍ مميّزٍ للقاء يا عمّو، كميثاق عهدٍ لمعرفةٍ بدأت في الأرض لتنتهي في السماء، وآملُ أن تحفظ توقيته ومكانه جيّداً.
ميعادنا مكانه الجنّة، ولا زمان له هناك!
في الجنّة لن نستطيع حفظ الطرقات، لجلالها وجمالها، قد تضيع منّا عناوين قصور الأحباب وبساتينهم، ستكون تلك أجمل ضيعاتنا؛ سأعطيك عنواناً لا تنساه ولا أنساه، اتّفقنا؟
ليكن موعدنا عند قصر الصّحابيّ الجليل رضي الله عنه وأرضاك «عُكاشة»، جميعنا في شوقٍ لرؤيته.
مررتَ على عمري كأحدٍ يشبهه، كنتُ من بعدكَ كلّما ساعدني أحدهم وَهممتُ بالامتنان له أقولها سرّاً في قلبي: «سبقك بها عكاشة»، وأنا أعنيك ملئ القول والرّوح يا عمّو.
عند قصره حديقةُ أطفالٍ أماميّة سمّيتها: «حديقة حليمة»، بستانٌ من مائة نخلةٍ باسقةٍ زرعتها كاتبةٌ مغتربةٌ بعد قراءة مقال البحث عنّي؛ هناك سأنتظرك، مع كومٍ من الأطفال، لنقول لك: «شكراً» عدد أطفال المجرّة المهاجرين يا عمّو، شكراً.
«حليمة هيثم».
= هامش:
المقال المعني موجود على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان: البحث عن حليمة.
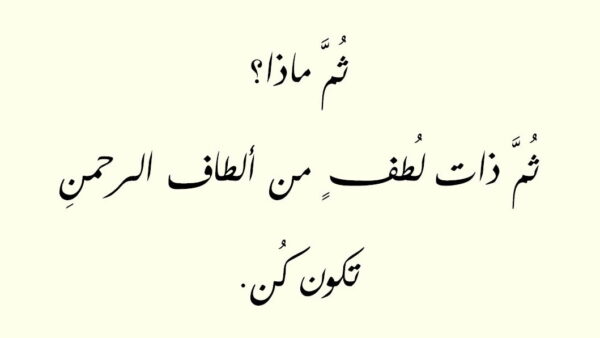

شكراً من القلب ❤️
اكتبها لكِ من القلب ❤️