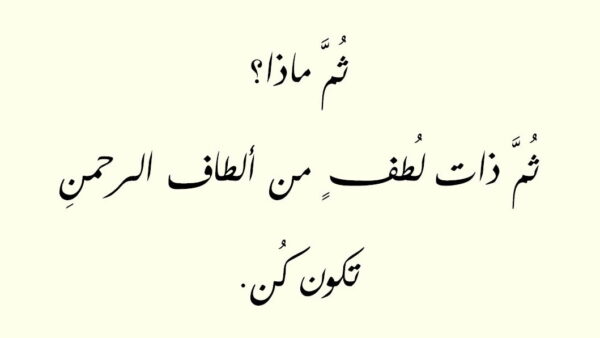تسألني حمامة الأيكِ البارحة دون مقدّمات؛ خالة: ما حنملّ بالجنّة؟ يعني كيف هيك؟ نعيش بدون ما يكون عندنا شي نساويه؟ نحلم فيه؟ نستنّاه؟ نتفاجأ لمّا يصير؟
خالة، شو بدّك تعملي أول سنة بالجنّة؟
تسترسلُ قبل أن تسمع الأجوبة التي أشكّ أنّها تريد سماعها..
خالة، برسالة الغفران، المعرّي تخيّل أنّه شاف كلّ الشعراء اللي سبقوه بالجنّة.
وترجع للسؤال: خالة، مين بدك تشوفي بالجنّة؟
أتنهّد، تنهيدةً لم تَرُقْها غالباً، فتستكملُ الجوريّةُ مهرجان الأسئلة؛ خالة، شو أكتر شي بدّك ياه بالجنّة؟
أتبسّم، بسمةً مُبطّنةً تعرفُ أنّ في جعبتها الحكاية، فتكملُ أنّها تريد أن تَضيعَ سنةً في مكتبة الجنّة دون أن يعثر عليها أحد.
يدور الحوار بيننا في آخر ليالي العيد، الجنّة المرتبطة به هي ذاتها النّعيم المُقيم المرتبط بالحساب المسبق، بالأخذ بالأسباب، بالعمل، هي الجائزة التي حلمنا بها منذ الطفولة، البلسم الذي سيمسح على الذكريات مَسحةَ الرّضا الأبدية، اللّعبةُ التي لن تنتهي والسعادة التي لن تُملّ.
من يدخل جنّة الدنيا، يدخل جنّة الآخرة بإذن الله، هل دخلنا الأولى حقاً؟
أظنّ ذلك ولله الحمد، بل أدعوه أنّه كان يقيناً وليس مجرّد ظنّ.
كانت كما وصفها فريد: «الحياة حلوة بس نفهمها».
«حلوة»، مثل أيّ منتج تشتريه أنت وصديقك معاً، تُحافظ عليه عشر سنين وتتمتّع به ويخدمك، ولا يعيش عنده أكثر من ستة أشهر، لأنّه لم يقرأ الكتالوج المرفق به لخمس دقائق، فأساء الاستخدام وضيّعه.
كم نخسر مثل تلك الخسارات في حياتنا لقصورٍ في الإدارة والإرادة، كم كنّا نستطيع أن نستلذّ بحياةٍ حلوة، لكنّنا لم نحسن التّصرف.
جنّة؟ حلوة؟
هل هي حقاً كذلك؟
نعم.
كفانا من مُتعها نعيمُ «العائلة».
تتصلّ بهم في العيد، تقول لك عمتك من القاهرة: «وبعدي قلبك شو اشتقتلك، تقول بأنها كانت في زيارة لبيت احما ابنها صباحاً».
تضحكين ضحكة المشتاق للمشتاق وتستجوبينها: «تقصدين أنّي بعد عشرين عامٍ سأزور صباح العيد الثالث منزل أهل زوجة ابني معه؟».
تضحكان معاً على بعد آلاف الكيلومترات، وتضحك الحياة، لأنّها لا تعرف أحياناً أن تخبّئ أسرارها بسبب ثرثرة العمّات الجميلة.
يقول لك خالك من حلب: «تفضّلي، الغدا فريكة، والله منشتهيكن».
وقلبك قبل لسانك يقول له: «مطرح ما يسري يمري يا خال».
تمازحينه: «كيفها المدام؟ عم تغلّبك شي؟».
تسحب منه السمّاعة: «شو قصدك، هيك صار الحكي؟».
فتضحكون جميعاً ثانيةً عبر مكالمةٍ مجانيةٍ مسنجريةٍّ سبيكريّةٍ من غرفةِ ضيوف الجدّ الثاني في الرياض تصل إلى مطبخ بيت الجدّ الأوّل في الشهباء، تقولين لها: «خالي أصبح جَداً، لديكم بدل الصهر صهرين، والكنّة قادمةٌ لا محالة، لا بدّ أن أسأله عنكِ كعروسٍ كي لا يقرّر اخضرار عوده بلا سابق إنذار، نحاول أن نسبقه بخطوة ليس إلاّ يا مرت خالو».
تسألك خالتك الثانية من مكة ممازحةً بسبب ضجيج الصغار: «نبعتلكن شوية أحفاد تتسلوا معهن؟».
ترتعبين وتصارحينها: «لَه لَه يا خالتي، كنت سأعرض عليكِ نفس العرض».
ويقول لك عمّك من الإمارات: «يا عمّو البرامج هون مو شغّالة حأسجّل لك صوت أتطمن عليك وعلى ولادك وأهلك».
بدى خالك في مرسين، وسيماً كعادة الخيلان، خالٌ كلّما كبر وازداد عدد أحفاده حفيداً بدت بسمته أحلى وأحلى تخطفُ قلبكِ الصغير خطفاً.
قد لا تملك في مدينتك اليوم أخاً أو أختاً أو أماً أو حتّى ابناً!
ما بين الأمريكتين وألمانيا والأردن والسعودية تتوزّع على أرجاء الخريطة عائلةٌ كانت في زمنٍ مضى تتناول افطارها حول صينيةٍ معدنيةٍ مستديرة تحوي كاسات شايٍ صغيرة، وتستبق أياديها صحون اللبنة والزعتر والزيتون، وتستأذنُ على استحياءٍ لقمة البيض المقليّ الأخيرة، تحلمُ كلّ عيدٍ بالتقاط صورةٍ جماعيّةٍ واحدةٍ تضمُّ وجوههم للذكرى، واحدةٌ لا أكثر، سبحان الدايم، والله كريم.
صيفيّات