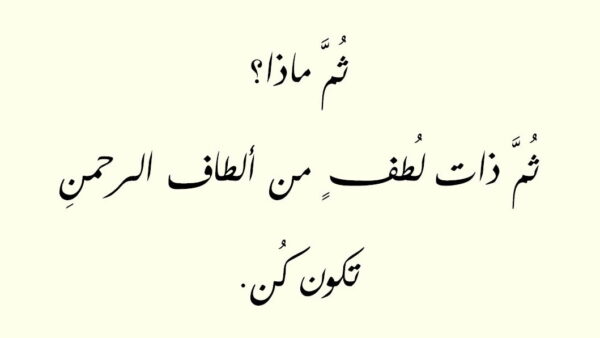كيفَ هو قلبكِ اليوم؟
كم سؤالاً وذكرى مرَّت على خاطرك بالأمس؟
هل استشعرتِ مثلي أن الموت بالسرطان يمنح أرحام المريض فرصة وداع أخيرة، أحنّ من فرصة وداع مريض الكورونا بغتةً!
لقد بكيتُ البارحة كما لم أبكِ منذ زمن،
زمني عادةً لا يتجاوزُ الأسبوع، دمعي قريبٌ وقلبي أخرق، وأدعو الله أن يعفو عنّي لما سببته من اضطراب لكلّ سائقي مدينتي حين رأوني أبكي عند الإشارات الحمراء لأسكُبَ حملاً ما أثقل قلبي.
تفريغُ الدّموع ثلاثة دقائق في السيارة وحيدةً، أهونُ من البكاء في دورة مياه يطرقُ بابها ألفَي مرّة ابني أحمد ليتفقّدني.
من قال بأن البكاء لا يليقُ بالأمهات؟
بل بمثلنا يليق،
لولا تلك الدمعات لنعتونا بعُقلاء المجانين،
بفضلها سراً، تألّقنا أمامهم بطلّةٍ بهيّة، وظنّوا بغفلةٍ منهم أنّا أعقلَ العقلاء.
نبكي، نغصّ بشهقةٍ طويلةٍ عميقة، وما نفعُ البكاء؟
مليارُ دمعةٍ لن تسمحَ لي بقراءةِ رسالةٍ واحدةٍ من أبي بقية عمري، يقرؤني فيها السلام، يصفُ لي فيها البرزخ ونعيمه،
قلبي فُطرَ تماماً آخرَ أيّامي معه.
هيّؤونا أن العملاقَ سيرحل؛ بقي ثلاثة أشهرٍ على الأكثر.
أخبرونا أنّا واياهُ سنمرُّ الآن بمرحلةِ إنكار،
والدي الذي تمنيتُ أن أراهُ بشيبٍ كامل، غادر وسيماً كأوسمِ ما عرفتُ الآباء.
سجّلي صوته دون أن ينتبه، دون أن يشعرَ أو يُحسَّ فيعلم، ولا تسأليني لمَ!
تأتيك أيامٌ ثِقالٌ تحتاجين رفعَ صدى ذلكَ الصوت الحنون في المنزل،
وحده الأب،
بطلنا الأول والثاني والعاشر.
وحده الأب الصالح يُكوّن في عقول الفتيات صورةً بهيةً متألقةً عن فارسِ الأحلام.
ووحده أبي،
جعلني أتأمّل منذ الطفولة أن الله يكنزُ لي في ألطافه داود خاصّتي.
اللهُ الذي خلق أبي لأمي، خلق داود لشفاء، داودٌ “فيه شفاء”.
ربّما كُتب ذلك القدر مع كتابة اسمي لأوّل مرّة، حين سمّاني شفاء.
لم أنْتَمِ لذلك الاسمِ يوماً، غيرَ أن النغم كان يسحرُني، شفاء تيسير داود.
هل كنت شفاءه؟
كم كان يريدُ لتلك الشفاء أن تكون اسماً على مسمى خلال هذا العمر الجميل.
ليس سهلاً أن تفيضي بعاطفةٍ لا تنضب، كل يوم كل لحظة، أنت اسمك وأنا اسمي ونحن جميعاً أسماؤنا.
أريدكِ الآن أن تقرئي اسمك الثلاثي، تكتشفين أنه كان يريد بهذا الاسم سراً له، ليس أن يسميك به فقط.
هذا العامُ ذو شجون، كلّما حاولنا أن نتجنّب ذكرَ الموت، نجدُ أنّه لا يتجنبنا.
نجدُ أن إدراك أنّه فعلاً “يرقصُ لنا في كلِّ منعطفِ”، هو الوعي الشاملُ لعيشِ حياةٍ عظيمةٍ تستحقُّ بجدارةٍ أن تنعت بالحياة.
تراسلنا أختي الصغرى منذ أيام،
متفاجئةً أن الأمّ السّبعينية تبكي وفاة أبيها التّسعينيّ.
تقولُ: حُقّ لي أن أبكي بقيّة العمرِ ألماً على رحيلِ أبي في عشريني إذاً؛ أنا أحسدُ من عاشوا مع أباءهم كلّ هذا العمر، أنا لم أشبع منه بعد.
وددتُ أن أقول: والله ولا أنا بعد؛ لكن تلك القولة لا تليقُ بي في مقامٍ يُتوقّع منّي فيه تمثيلُ قوّة الأختِ الكبيرة.
تستطردُ، نصُّكِ الأخير، أرى أن تفصلي بين نصّ أمِّنا ونصّ عمّنا، أراهم نصّين منفصلين.
قلت: كلاّ، لم أستطع أن أنعى أحدهم دون أن أعبّر لأمّي عن حبي وشوقي ما حييت، وعن خوفي المريع كلّ يومٍ أن ترحل.
نحن لا نبكي موتهم، نحن نبكي أنفسنا بعدهم، تقصيرنا بحقهم، عدم إدراكنا عظمةَ وجودهم،
نبكي قلق الوحدة، وطأة الحنين، عصرةَ قلوبنا مُستقبَلَ السنين.
وحدهُ الرحمن، يعلمُ أيّ القلوبِ نملكُ يا صديقتي.
إلى المعنيّة، إلى صاحبةِ الرسالة.
أمومتكِ هي التي ستسندك وأنت تودعين أبوّته،
تحمدين الله عمراً بل ألفَ ألفِ عمرٍ أن كنتِ في هذا العمر ابنته، أن كان مثالاً عظيماً للرجلِ والأبِ في حياتك،
تجلسينَ بقربي يوماً، نعيدُ سردَ الذكريات ونقتات عليها بين الفينة والأُخرى.
لا أملكُ إلاّ أن أقول لكِ: اثبت أحد، ربطَ اللهُ على قلبك، عند الحوض نلقاهم ونلتقي، في الجنة لا نبكي، وبها نستريح.